

 |
 |
 المناسبات
المناسبات |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
المتعاطفات في آية الوضوء
– قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة: 6]. سؤال: هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي عن الغَسْل وهو المسح بالرؤوس؟ ثم لماذا فعل ذاك؟ الجواب: لا شكَّ في صِحَّة هذا العطف في اللغة، وهو كثير في القرآن وغيره، قال تعالى:﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾[الروم: 17-18]. فقد عطف:﴿حِينَ تُظْهِرُونَ﴾ على:﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ وبينهما متعاطفات فقوله:﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ معطوف على قوله:﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾، و ﴿الْأَرْضِ﴾ معطوفة على ﴿السَّمَاوَاتِ﴾. ونحو ذلك آية الكرسي، فإنَّ قوله: ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾[البقرة: 255] معطوف على قوله في أول الآية:﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ وبينهما مُتعاطفات مختلفة وهي:﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وبينهما متعاطفات مختلفة وهي:﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله:﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، وقوله:﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ونحو ذلك قوله تعالى:﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾[البقرة: 177]، فعطف:﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ على ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي (ومَن أقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات. وقال تعالى في سورة الجن:﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾[الجن: 16]، فعطف هذه الآية على قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾[الجن: 1] وهي الآية الأولى. فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى. وفي سورة الأعراف عطف قوله: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾[الأعراف: 85]. على قوله:﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾[الأعراف: 59]. على ما بينهما من بُعد، وذكر قصصاً مُتعددة ومُتعاطفات كثيرة، فإنَّ بينهما ستاً وعشرين آية، فلا خلاف في صِحَّة نحو هذا. تقول في الكلام: (ذهبت إلى السوق فاشتريتُ من البقَّال فاكهة وخضروات وبيضاً، ومن البزاز قماشاً وقميصاً، ومن المكتبة كتابين ودفتراً ثم عُدت)، فتعطف الفعل (عدت) على (ذهبت) في أول العبارة على ما بينهما من مُتعاطفات مُتعددة مختلفة. أما لماذا فعل ذلك في آية الوضوء، فإنَّ الغرض إرادة الترتيب في الوضوء، فإنَّه يجب أن تكونَ أعمالُ الوضوء مُرتَّبة بحسب ما ذكره القرآن الكريم. ............ اختلاف وصف القوم في آيتَي: (فلا تأسَ على القوم) لماذا قال تعالى في سورة المائدة:﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[المائدة: 26]. وقال في السورة نفسها: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾[المائدة: 68]. الجواب: إنَّ الآية الأولى قالها ربنا جل وعلا في قوم موسى عليه السلام الذين نكلوا عن قتال الجبَّارين، وقالوا: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[المائدة: 24-26]. وقوم موسى عليه السلام ليسوا كافرين، وإنما هم فاسقون لمخالفة أمر الله تعالى في القتال، ثم إن هذا الوصف مجانس لما وصفهم به موسى عليه السلام بقوله:﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[المائدة: 25]، فقال له ربه:﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[المائدة: 26]. وأما الآية الثانية فهي خطاب لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به، قال تعالى:﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾[المائدة: 68]. وهؤلاء كافرون فإنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله تعالى في هذه الآية:﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾[المائدة: 64]، فذكر أنه يزيدهم ما أُنزل إليه طغياناً وكفراً، فقال فيهم:﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[المائدة: 26]. 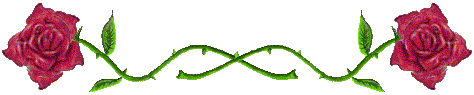 تعدية الفعل: تقبَّل تارة بـ (من) وأخرى بـ (عن) قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[المائدة: 27]. وقال سبحانه في سورة الأحقاف: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾[الأحقاف: 16]. سؤال: عدّى الفعل (تقبَّل) في آية المائدة بـ (من) فقال: ﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ....قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وعدّى الفعل في آية الأحقاف بـ (عن) فقال: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾[الأحقاف: 16]، فما السبب؟ الجواب: إنَّ تعدية الفعل (تقبَّل) بـ (من) تدل على الاهتمام أو العناية بالذات أو الجهة التي يُتقبَّل منها. وتعديته بـ (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنها، فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عدّاه بـ (من) وذلك نحو قوله: ﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾[المائدة: 27]، وقوله:﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[البقرة: 127]، وقوله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾[آل عمران: 35]. أما إذا كان محطَّ العناية والاهتمام على العمل وقبوله فإنه يعدِّيه بـ (عن) وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أي: نتقبل العمل الصادر عنهم. وحيث عدّي الفعل (تقبل) بـ (من) لم يذكر له مفعولاً أو هو يبنيه للمجهول مما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها. فإذا عدّاه بـ (عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم. فدلّ على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل بـ (عن)، ومناط الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته بـ (من)، والله أعلم. 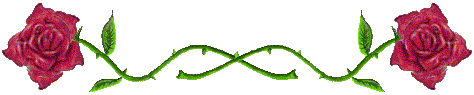 حول التعقيب في آيتَي: {وإن يمسسك الله بضر} قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[الأنعام: 17]. وقال سبحانه في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾[يونس: 107]. سؤال: لماذا اختلف التعقيب في الآيتين فقال في آية الأنعام:﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وقال في آية سورة يونس:﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾؟. الجواب: إنَّ آية الأنعام في افتراض مسِّ الخير، فقد قال:﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾، وأما آية سورة يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المسّ، فقد قال:﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾[يونس: 107]، والإرادة من غير الله تعالى قد لا تتحقق لأنَّه قد يحول بينها وبين وقوعها حائل، وأما إرادته سبحانه فلا رادّ لها. فاختلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام. ألا ترى أنه لما اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الجوابان، فقد قال في كل منهما:﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾؟ ولما اختلف الافتراضان كان الجواب بحسب ما يقتضيه كل افتراض. ,,,,,,, ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ [العنكبوت آية:١٤] ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إﻻ خمسين عاما ﴾ العام يطلق على الخصب والخير السنة تطلق على الشدة والقحط . ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ ﴾ [البقرة آية:١٧٣] (غفور رحيم) قيل : سبب تقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة ، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ ﴾ [المؤمنون آية:٥] إنّ اختيار هذا التعبير اختيارٌ عجيب، وفيه آياتٌ عظيمة لمن تدبَّر ونظر! فلم يقل: (ممسكون) أو نحو ذلك؛ لأنّ الذي يمسك فرجه عما لا يحل يكون حافظًا لنفسه من العقاب والآفات والأمراض والأوجاع!
اختار لفظ (لَا تُلْهِكُمْ) ولم يقل (تشغلكم)، والحكمة في ذلك أن من الشغل ما هو محمود؛ فقد يكون شغلًا في حق، كما جاء في الحديث: «إن في الصلاة لشغلا» وكما قال تعالى: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ) (يس:٥٥)، أما الإلهاء فمما لا خير فيه؛ وهو مذموم على وجه العموم، فاختار ما هو أحق بالنهي.
قال تعالى عن إبراهيم: (شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ)، وقال: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) ، فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعم)؛ لأن نعم الله لا تحصى، وإنما يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرها وهو ما كان من إبراهيم، فذكر جمع القلة في هذا المقام، أما آية لقمان فجمعها جمع كثرة (نعمه)؛ لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًا.
لا تجد في القرآن ذكر (المطر) إلا في موضع الانتقام والعذاب بخلاف (الغيث) الذي يذكره القرآن في الخير والرحمة؛ قال تعالى: (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ)، في حين قال (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ).
تَدرُّجٌ من القلة إلى الكثرة، ومن الأفضل إلى الفاضل؛ إذ قدم ذكر (الله) على (الرَّسُولَ ) ورتب السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم كما تدرج من القلة إلى الكثرة، فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق عددًا، ثم الصديقين وهم أكثر، فكل صنف أكثر من الذي قبله.
اختيار كلمة (النجدين) في هذه السورة بينما في السور الأخرى جاء التعبير (إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) و (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) وغيرها؛ لمناسبتها جو السورة، فإن سلوك النجد فيه مشقة وصعوبة؛ لما فيه من صعود وارتفاع، فهو مناسب للمكابدة والمشقة التي خلق الإنسان فيها، ومناسب لاقتحام العقبة وما فيه من مشقة وشدة.
صيغة الاسم تفيد الثبات والدوام وصيغة الفعل تفيد التجدد والاستمرار، ومن لطائف هذا التعبير قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )، فجاء الفعل (لِيُعَذِّبَهُمْ)؛ لأن بقاء الرسول بينهم مانع مؤقت من العذاب وجاء بعده بالاسم (مُعَذِّبَهُمْ)؛ لأن الاستغفار مانع ثابت من العذاب في كل زمان. تدارس القرآن الكريم |
|
|

|
|
|
#14 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾ [الأعراف آية:٧٨] ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾ [هود آية:٦٧] (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) وقال: (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) ، فحين ذكر الرجفة -وهي الزلزلة الشديدة- ذكر الدار مفردة (فِي دَارِهِمْ)، ولما ذكر الصيحة جمع الدار (فِي دِيَارِهِمْ)؛ وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها مساحة أكبر مما تبلغ الرجفة التي تختص بجزء من الأرض؛ فلذلك أفردها مع الرجفة وجمعها مع الصيحة. ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ ﴾ [الأعراف آية:١٣١] لو تدبرت التقابل البديع في هذه الآية لوقفت خاشعًا لله! انظر كيف عبر في جانب الحسنة بالمجيء! في حين عبر في جانب السيئة بالإصابة! لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. وفي التعبير عن السيئة بـ(تُصِبْهُمْ) دقة؛ فالإصابة وحدها توحي بالسوء، فكيف إذا عَدَّى الإصابة بالسيئة فهو ألم فوق ألم! ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ ﴾ [الحج آية:٢٦] ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ ﴾ [البقرة آية:١٢٥] قال في سورة الحج: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ) وقال في سورة البقرة: ( أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ) ، فلم يذكر الاعتكاف في الموضع الأول، وذلك لأنه ذكر بعده فريضة الحج والحجاج الذين يأتون من كل فج عميق، ومن هؤلاء من سيعود إلى أهليهم بعد قضاء فريضة الحج، فلا يناسب ذلك ذكر العكوف والإقامة، وإنما يناسبه القيام. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾ [يس آية:٨٢] ﴿ أن يقول له كن فيكون ﴾ فيكون ولم يقل ثم يكون؛ للدلالة على التعقيب، وأنه يكون ما أراده مباشرة كما أمر، وليس في ذلك تراخ أو مهلة. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ ﴾ [البقرة آية:٢٥٥] " لا تأخذه سنةٌ ولا نوم " قدّم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ ﴾ [الكهف آية:٣١] آية (31): * في سورة البقرة يقول تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ (25)) وفي الكهف يقول (أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)) فما الفرق؟(د.فاضل السامرائى) من تحتها الكلام عن الجنة (وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) البقرة) ومن تحتهم يتكلم عن ساكني الجنة المؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) الكهف)، الكلام على الساكن، على المؤمن. إذا كان الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم) وإذا كان الكلام على الجنة يقول (من تحتها). قد يقول بعض المستشرقين أن في القرآن تعارض مرة تجري من تحتها ومرة من تحتهم لكن نقول أن الأنهار تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين ليس فيها إشكال ولا تعارض ولكن الأمر مرتبط بالسياق عندما يتحدث عن المؤمنين يقول (من تحتهم). قبل آية الجنة تكلم عن المؤمنين (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) لما يكون الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم).وعندما يتكلم عن الجنة أكثر يقول (من تحتها). (مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) ص) *ما دلالة استعمال الوصف (متكئين) لأهل الجنة خاصة؟(د.فاضل السامرائى) الاتّكاء غاية الراحة كأن الانسان ليس وراءه شيء لأن الانسان لو وراءه شيء لتهيّأ له ولم يتكيء. والاتّكاء في القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات العائلية هذا أكثر ما ورد إلا في موطن واحد. مثل قوله تعالى (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) يس) والاتكاء يحسُن في هذا الموضع. وقال تعالى (مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) ص) يرتبط الاتكاء مع الطعام والشراب وكذلك في سورة الرحمن (مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54)) دائمايأتى في السياق ذكر الطعام والشراب. الآية الوحيدة التي لم تأت فيها كلمة متكئين مع الطعام والشراب هي الآية في سورة الكهف (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)). ونلاحظ في هذه السورة نجد أن الآية التي ليس فيها طعام وشراب سبقها قوله تعالى (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)) فكأنما الله تعالى يخاطب الرسول الذي كأنه يريد القيام فصبّره الله تعالى فجاءت متكئين في الآية بعدها فكأنها مقابلة فهؤلاء المؤمنين في راحة وأراد تعالى أن يًصبّر رسوله . فالاتكاء غاية الراحة ولهذا وًصِف به أهل الجنة ولم يأت وصفهم بالنوم لأنه لا نوم في الجنة أصلاً. ووصِفوا في القرآن بأوصاف السعادة فقط يتحادثون فيما بينهم ويتذاكرون ما كان في الدنيا والاتكاء غاية الراحة والسعادة. * في القرآن الكريم يستخدم الفعل المضارع في وصف أفعال أهل الجنة (يحلون فيها، يلبسون، يشتهون) أما في أفعال أخرى في الآخرة يستخدم الفعل الماضي فهل من لمسة بيانية في هذا الخصوص؟(د.فاضل السامرائي) ليس دائماً لكن حسب الآية نفسها والسياق (إ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) الكهف) هذه تدل على المستقبل، (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) لما كان الكلام على المستقبل جاء بالفعل المضارع (يحلّون) يتكلم عن أمر في المستقبل. لكن في مكان آخر يستعمل الماضي مثلاً في سورة الإنسان قال (وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)) لأنه قال (وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)) قال جزاهم، هذا حدث في الماضي لأن الفعل الماضي أحياناً يستعمل بمعنى المستقبل للدلالة على أن هذا بمنزلة الماضي ليس فيه شك. هي أحداث مستقبلة، العرب - والقرآن بالغ فيها كثيراً - يستعملوها بمعنى الماضي بمنزلة الماضي كأن الأمر قد وقع تحقق وثبوت (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ (68) الزمر) لم ينفخ بعد ولم يصعق (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) الحاقة) لم تحمل بعد، (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا (71) الزمر) هذا كله في المستقبل وعبّر عنه بالماضي لتحققه بمنزلة الماضي الذي وقع والذي ليس فيه شك أو بمنزلة أنه حدث (وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)) (وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)) جزاهم، تلك الكلام عن المستقبل وهنا الكلام كأنما هو عن الماضي، كل واحدة تناسب كل موقف وكل مشهد وكل حالة.
* آية المال والبنون (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) الكهف) هل الواو حرف عطف وهل حرف العطف يهتم بأن المال أهم من البنون أو أن المال يأتي أولاً لأجل البنون؟(د.فاضل السامرائى) الواو هنا عاطفة وهذا يدخل في باب التقديم والتأخير قدم المال على البنين هنا لأنه قال زينة الحياة الدنيا والزينة بالمال أظهر من البنين فقدم المال لأنه لما قال زينة قدم ما هو أدل على الزينة (وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ (6) الإسراء) وتقدم الأموال على الأولاد بحسب السياق. قال تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (14) آل عمران) هنا أخرها (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) التوبة) أخر الأموال، لما يذكر مسألة الحب الفطري يؤخر الأموال لأن الأموال تترك للأبناء يعمل ويكد ويعلم أنه ميت ويترك الأموال للأبناء. أحياناً نرى كلمة متقدمة وفي موطن آخر نراها متأخرة كما مر بنا في النفع والضر. الواو لها أغراض أخرى في اللغة غير العطف مثل واو القسم (والليل) واو الحال (إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (8) يوسف) واو الاسئتناف، واو الثمانية قالها بعض النحاة ورفضها عموم النحاة وأنا شخصياً لا أقبلها. |
|
|

|
|
|
#15 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
*متى تستعمل يا ويلتنا ويا ويلنا؟ (وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (49) الكهف) و(قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) القلم)؟(د.فاضل السامرائى) الويل هو الهلاك عموماً والويلة هي الفضيحة والخزي. الويل هو الهلاك (ويل للمطففين)، (ويل لكل همزة)، (يا ويلنا إنا كنا ظالمين). (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) هود) فضيحة قالت يا ويلتى ولم تقل يا ويلي، المرأة تقول يا ويلي وإذا أرادت الفضيحة تقول يا ويلتي. فإذن الويلة هي الفضيحة والخزي. (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) الكهف) سيفضحنا، كل الأفعال التي فعلوها ستظهر يا للفضيحةّ وهناك أعمال هم لا يحبون أن يطلع عليها أحد وستفضحهم فقال (يا ويلتنا) لأن فيها أعمال وخزي وفضيحة وهم يحبون أن يستروها فقالوا (يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا). ورد على لسان ابني آدم (قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) المائدة) يا للفضيحة والخزي والعار هذا الغراب فكّر أحسن مني. (يا ويلنا) هي ويل هلاك (ويل للمصلين) هذا للهلاك. إذن ويل للهلاك وويلة للفضيحة والخزي هذا في اللغة. ويلة تأتي يا ويلتى أو يا ويلتي أو يا ويلتنا للجمع. ويل تأتي ويل.
* (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (50) الكهف) هل (كان) هنا بمعنى صار؟(د.فاضل السامرائى) (كان) تأتي لمعاني كثيرة طويلة وليست بالبساطة التي يأخذها الطلبة. قد تأتي للإنقطاع كأن تقول (كان نائماً، كان في البيت) أمر حصل وإنقطع. وقد تأتي بمعنى الوجود على الأصل أي هو هكذا (وكان الإنسان عجولا) هذا ليس انقطاعاً، لم يكن عجولاً ثم صار عجولاً، يقولون هو بمعنى الوجود على الأصل أي هكذا وُجِد. (كان من الجن) أي هكذا خُلِق على الأصل. في النحو هناك (كان) تامة و (كان) ناقصة. (كان من الجن) ناقصة تحتاج لإسم وخبر. (كان) بحد ذاتها عند النُحاة فيها كلام طويل: "ما كان ليفعل، ما كان له أن يفعل"، فيها استعمالات خاصة بقية الأفعال لا تشابهها. أما (كان) تأتي تامة (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ربنا يقول له صِر فيصير. (وإن كان ذو عسرة) بمعنى إن وُجِد. (كان) التامة بمعنى وُجِد لا تحتاج لإسم أوخبر (وذو تمام) وإنما تحتاج لفاعل.(إلا إبليس كان من الجن) هنا ليست بمعنى صار وإنما هو في أصل خلقته من الجنّ.
آية (54): *ما الفرق بين قوله تعالى (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) الإسراء) وقوله (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) الكهف)؟ (د.فاضل السامرائى) قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخّرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام في الإسراء على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به فقال (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) ) إلى أن يقول (وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) ) فناسب تقديم الناس في سورة الإسراء. ولم يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) ) فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس، فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء. وأما في سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأت بقوله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (1) )ثم تكلم على بني إسرائيل ثم قال بعد ذلك: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) ) فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في الموضعين. ثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) ) والكفور هو حجد النعم فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من السياق. أما آية الكهف فقد ختمها بقوله (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) ) لما ذكر قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى (فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ (34) ) وقوله (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ (37) ) وبعدها (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ (56) ) وذكر محاورة موسى الرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. وقال (فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا (22) ) ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!. ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [الروم آية:٣٦] *ما الفرق بين بما قدمت أيديكم وبما كسبت أيديكم ؟ التقديم أن تعطي وتقدم مما عندك أما الكسب فأن تجمع وتأخذ بنفسك. ننظر كيف يستعمل القرآن قدمت وكسبت: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم) قبلها ذكر كسباً غير مشروع (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) الروم) هذا كسب فقال بما كسبت أيديكم كسب وليس تقديم. آية الشورى (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30)) قبلها ذكر كسب وسوء تصرف (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)) هذا كسب فقال كسبت. آيات التقديم ليست في سياق الكسب مثال (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) الروم) قبلها قال (وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33)) ليس فيها كسب. (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ (48) الشورى) ليس فيها كسب، (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) آل عمران) كأن هذا الكلام مقدم من قِبَلهم، (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) الأنفال) التقديم لما فعلتم وقدمتم لآخراكم لكن الكسب يكون في نطاق الكسب والاستحواذ. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [البقرة آية:١٦] *ما الفرق بين الفسق والضلالة؟ الضلال هو نقيض الهداية (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى (16) البقرة) لكن الفرق بين الفسق والضلال أن الضلال قد يكون عن غير قصد وعن غير علم. الضلال هو عدم تبيّن الأمر تقول ضلّ الطريق قال تعالى (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) الكهف) هذا من دون معرفة ضلّ ولا يعلم، ضل عن غير قصد. وقد يُضلّ بغير علم (وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ (119) الأنعام) أما الفسق فهو بعد العلم تحديداً وحتى يكون فاسقاً ينبغي أن يكون مبلَّغاً حتى يكون فسق عن أمر ربه. إذن هنا زيادة أنهم مبلّغون ثم خرجوا فإذن هم فاسقون لو قال ضالون قد يعطيهم بعض العذر أنهم عن غير قصد لكنهم فاسقون بعد المعرفة وبعد التبليغ فسقوا. في قوله (ولا الضالين) ولا الضالين عامة لأن الضلال عام واليهود والنصارى منهم وليس حصراً عليهم. (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) النجم) نفى عنه الضلال بعلم أو بغير علم أما الفسق فلا يكون إلا بعد علم، ينبغي أن يعلم أولاً حتى يقال عنه فاسق (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) هذا بعد التبليغ (فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) تنكّبوا الصراط بعد المعرفة. أصل الفسق هو الخروج عن الطريق يقال فسقت الرطبة أي خرجت من قشرتها. ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [البقرة آية:١٧] *ما سبب استخدام المفرد والجمع في قوله تعالى في سورة البقرة (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ {17})؟ 1. من الممكن ضرب المثل للجماعة بالمفرد كما في قوله تعالى (لا تكونوا كالتي نقضت غزلها...تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم(92)النحل). 2. (الذي) تستعمل للفريق وليس للواحد فالمقصود بالذي في الآية ليس الشخص إنما هي تدل على الفريق ويقال عادة الفريق الذي فعل كذا ولا يقال (الفريق الذين). 3. يمكن الإخبار عن الفريق بالمفرد والجمع (فريقان يختصمون) 4. الذي نفسها يمكن أن تستعمل للمفرد والجمع. كما جاء في الشعر العربي: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ ﴾ [الروم آية:٦] آية (6): *ما الفرق بين كثير من الناس وأكثر الناس (وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ (18) الحج) (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) الروم)؟ (أكثر) هذه صيغة إسم تفضيل، (كثير) صفة مشبهة. كثير جماعة قد يكون هم كثير لكن ليسوا هم الأكثر، الأكثر أكثر من كثير (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) يوسف) لكن المؤمنين كثير موقع تدارس القرآن الكريم |
|
|

|
|
|
#16 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [الروم آية:٤٤] *في سورة الروم قال (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) إذا قارنا بين هذه الآية وآية سورة لقمان (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) فما اللمسة البيانية فى الاختلاف بين الآيتين؟ هناك أكثر من اختلاف بين الآيتين. نلاحظ أنه في آية الروم قدّم الكفر وأخّر العمل (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) ثم نلاحظ أنه ليس هذا فقط وإنما ذكر عاقبة كلٍ من الفريقين في آية الروم بينما في لقمان ذكر فقط عاقبة الشكر ولم يذكر عاقبة الكفر (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) بينما في آية الروم ذكر عاقبة الإثنين (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) ذكر عاقبة الكفر (فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) وعاقبة الإيمان والعمل الصالح (فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ). أما في لقمان فذكر عاقبة الشكر (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) يستفيد هو لأن عاقبة الشكر يعود عليه نفعها أما في الكفر لم يذكر شيئاً وما قال يعود عليه كفره. بينما في الروم فقال (فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) ذكر العاقبة، هناك لم يذكر. إذن صار الخلاف أيضاً من ناحية الجزاء ذكر في لقمان ذكر جزاء الشاكر ولم يذكر جزاء الكافر وفي الروم ذكر جزاء الإثنين الكافر والعمل الصالح. وفي الروم ذكر الفعلين بالماضي (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)). حتى المقابلة في لقمان قال (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) الكفران بمقابل الشكر بينما في الروم قال (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) اختلفت. فهي إذن ليست مسألة واحدة بين الآيتين وإنما أكثر من وجه للإختلاف بينهم والسياق هو الذي يحدد الأمر. لماذا قدّم الكفر على العمل الصالح في آية سورة الروم؟ ذكرنا أن التقديم والتأخير هو بحسب السياق وهو الذي يحدد هذا الأمر. السياق في الروم هو في ذِكر الكافرين ومآلهم (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) إذن السياق في ذِكر الكافرين فقدّمهم وقال (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ). في لقمان قال (أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ) بدأ بالشكر فلما تقدم الشكر (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِِ) بدأ بالشكر قال (وَمَن يَشْكُرْ) التقديم والتأخير كله بحسب المناسبة لذلك نلاحظ يقدّم الكلمة في موطن ويؤخّرها في موطن آخر بحسب السياق الذي ترد فيه. في الأفعال في سورة لقمان (وَمَن يَشْكُرْ) بين مضارع وماضي بينما في الروم بصيغة الماضي (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) فلِمَ التنوع في الصيغة الزمنية في الفعل؟ آية لقمان فيمن هو في الدنيا (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12)) هذه كلها في الدنيا، آية الروم في الآخرة (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) يومئذ يصدعون ومن كفر بعد هذا اليوم أي يوم القيامة ليس هنالك عمل انتهى، ذهب وسيأتي ما قدّم عاقبة من كفر ومن عمل. أما في آية لقمان في الدنيا قال (وَمَن يَشْكُرْ) هو يمكن أن يشكر طالما هو في الدنيا. لكن آية الروم وقعت بعد قوله (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)) انتهى هذا ليس هنالك عمل، انقطع العمل. في الروم يتحدث باعتبار ما كان وما مضى أما في لقمان فيتحدث في الدنيا ولهذا جاءت (يشكر) في لقمان بالمضارع. الكفر ينبغي أن يُقطع وليس مظنّة التكرار والكفر ليس كالشكر لأن الشكر يتكرر. ذكر عاقبة الكفر في الروم (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) ولم يذكر عاقبة الكفر في لقمان. السبب أنه ذكر عاقبة الكفر في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة وقبلها قال (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)) هذا من عقوبات الكفر وذكر العاقبة فناسب ذكر العاقبة أيضاً في الكفر فلما ذكر عاقبتهم في الدنيا ناسب أن يذكر عاقبتهم في الآخرة. في لقمان لم يذكر ولم يرد هذا الشيء وذكر فقط الشكر ولذلك ذكر عاقبة الكفر والعمل في آية سورة الروم لأن هذا وقت حساب. *لِمَ قال (فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) ولم يقل مهّدوا لأنفسهم؟ أحياناً نعبر عن المضارع للدلالة على المُضيّ ويسمونه حكاية الحال الماضية مثلاً (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (91) البقرة) المفروض قتلتم، (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ (102) البقرة) المفروض تلت، (وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (18) الكهف) المفروض قلّبناهم. يستخدم المضارع أحياناً للدلالة على المضي، هذه تسمى حكاية الحال الماضية هي للأشياء المهمة التي تريد أن تركّز عليها تأتي بها بالمضارع إذا كنت تتحدث عن أمر ماضي، القتل أمر مهم جداً فقال (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ) قد تُحدث نوعاً من أنواع لفت النظر وهم يقولون إما أن تأتي بالماضي فتضعه حاضراً للمخاطب كأنه يشاهده تنقل الصورة الماضية إلى الحاضر بصيغة فعل مضارع فيكون المخاطَب كأنما الآن يشاهده أمامه أو أنك تنقل المخاطَب إلى الماضي فتجعله كأنه من أصحاب ذلك الزمن فيشاهد ما حدث. لذلك حتى البلاغيين يستشهدون بمن قتل أبا رافع اليهودي في السيرة لما يقصون القصة كيف قتل أبا رافع يحكي القصة يتكلم عن أمر مضى فيقول: فناديت أبا رافع فقال نعم، فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهِش، (قال فأضربه أبرز حالة اللقطة لم يقل فضربته). هذه تُدرس في علم المعاني وأحياناً في النحو في زمن الأفعال. ذكر في لقمان بمقابل الكفر الشكر (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) بينما في الروم ذكر الكفر والعمل فاختلف. الكفر لغةً له دلالتان: الكفر بما يقابل الشكر (وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ (152) البقرة) (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) الإنسان) (فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ (94) الأنبياء) إذن شكر يقابلها كفر وكفر النعمة أي جحدها. الكفر هو الستر في الدلالة العامة لما تأتي إلى التفصيل شكر يقابلها كفر، شكر النعمة يقابلها كفر النعمة، كفر بالنعمة أي جحد بها وعندنا الإيمان أيضاً يقابله الكفر وهذه دلالة أخرى. إذن كلمة كفر إما تكون مقابل الشكر وإما تكون مقابل الإيمان. إذا كان الأمر متصلاً بالنعمة فهي مقابلة للشكر وإذا كانت متصلة بالعقيدة أو عدم الإيمان فمقابلها الإيمان. العمل يأتي من متممات الإيمان آمن بالقلب وصدّقه العمل "الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل"، لذلك هو السؤال المقابلة تختلف في لقمان مقابل الكفر الشكر (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) في الروم مقابل الكفر الإيمان والعمل لأنه لما ذكر الشكر (أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) مقابل الشكر الكفر (وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ). الآن في الروم ذكر الكافرين والمشركين قبلها قال (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)) مقابل هؤلاء مؤمنين (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45)) فإذن قابل في لقمان الشكر بالكفر وهو يتحدث عن النِعم. . أما في الروم يتحدث عن العقيدة (كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) حتى مقصود الآية يؤدي إلى تغيّر الألفاظ وتغيّر دلالتها. في الروم (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45)) كل واحدة بمقابلها. لما ذكر الكفر مقابل الشكر ذكر الكفر بما يقابل ذلك. لما ذكر الشكر في لقمان ذكر الكفر بما يقابل ذلك فقابل الكفر في الروم بالإيمان والعمل الصالح وقابله في لقمان بالشكر. لا نستطيع أن نفهم آية من آي القرآن الكريم إلا من خلال السياق العام الذي تتحدث عنه الآية لذلك يقولون السياق هو أعظم القرائن. قال (فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) جاء بـ (إنما) للدلالة على الحصر لأنها تفيد الحصر، سيشكر لنفسه حصراً لأنه هو الذي سيستفيد ألأن الله تعالى لا يستفيد من شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين (فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) لأن الشكر ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ (7) إبراهيم) وهذه الزيادة تكون في الدنيا والآخرة إذن هي مآلها إليه الشاكر يعود شكره عليه (فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) (إنما) أداة حصر، حصراً ويسميها النُحاة كافّة مكفوفة. موقع تدارس القرآن الكريم |
|
|

|
|
|
#17 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
*(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (26) ما المقصود بـ (فما فوقها)؟ القدامى يفسرون هذه الآية أنها دلالة على قدرة الله تعالى وفي دراسة علمية حديثة تبين أن فوق البعوضة جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة فهل هذا ما كان يُقصد بالآية أن ما فوقها هو هذا الكائن الحيّ؟ هنالك أشياء تعيش على البعوضة وقد ثبت علمياً هذا. على أي حال من أبرز التفاسير قالوا فما دونها وقالوا فما فوقها في الدلالة يعني يذكر البعوضة وغيرها فلا يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها في الإستدلال على الأشياء التي يريدها وليس بالضرورة أن تكون (فما فوقها) يعني ما أكبر منها وإنما ما فوقها في الاستدلال فهذا يشمل ما هو أصغر من البعوضة وما هو أعلى من البعوضة كالذباب. إذن (فما فوقها) يقولون في الاستدلال على قوة الله وقدرته والحكمة في مظاهر القوة والاستدلال فتكون عامة لما ذكر ولما لم يذكر، لما ذكر وأشار إليه الأخ السائل ولغيره.
* الاستئناس (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) هل معناها الطرق والاستئذان؟(د.فاضل السامرائي) الإستئناس عكس الاستيحاش والوحشة يعني أن تختار الوقت المناسب للزيارة، تفكر هل هذا الوقت مناسب. مثلاً أنت تأتي الناس وتتوقع أنهم نائمين فهل تستأذن عليهم؟ أو طلاب عندهم امتحان فتذهب تستأذن؟ هذا ليس استئناساً حتى لو استأذنت هذا ليس استئناساً ، الاستئناس هو اختيار الوقت المناسب مما لا يدعو إلى الوحشة بحيث يستأنسون بك وتستأنس بهم . *(لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) (حتى) معناها الغاية؟ طبعاً. أن هذا هو الوقت المناسب. تستأنس ثم تستأذن، تختار الوقت المناسب للزيارة مما لا يدعو إلى الاستيحاش من قِبَلهم. حتى أنت لا ترتاح. * في سورة النور في الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)) وفي آية أخرى يقول (فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (61) النور) فلماذا قال في الأولى سلموا على أهلها لأنها ليست بيوتهم وفي الثانية قال سلموا على أنفسكم؟(د.فاضل السامرائي) قسم ذهب إلى أن قوله تعالى (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ) قسم ذهب إلى أن هذا في دخول البيوت الخالية التي لا سكان فيها أو المساجد تقول "السلام علينا تحية من عند الله مباركة طيبة" أو في الأثر أيضاً "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" إذا دخلت بيتاً خالياً وحتى إذا دخلت بيتك وليس فيه أحد، خالي، نقول السلام علينا تحية من عند الله مباركة طيبة أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقسم قال ليس بالضرورة هذا لأن السياق هؤلاء من ألصق المذكورين من شكة الالتصاق، قال في هذه الآية قال ممن أباح لهم الأكل (أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (61) النور) فقالوا الناس ألصق ببعضهم فقال (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ) لأن هؤلاء هم كونهم هم أنفسهم من شدة الالتصاق بهم أو كما قال (فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (54) البقرة) يعني هم أنفسهم ، والثانية هذه وضع آخر. هذه للناس الأجانب المذكورين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (27) النور) يعني الضيوف، هذا موضوع آخر. (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ) إما البيوت الخالية أو المساجد أو ألصق الناس بك، أما تلك فبيوت أخرى.
*ما الفرق بين مفهوم كلمة فاحشة والفاحشة في المفهوم القرآني مع الأخذ بالاعتبار آيات سورة النور التي تتحدث عن عقوبة الزنا؟ (د.فاضل السامرائي) أصل الفاحشة عموماً ما اشتد قُبحه وما عظم من الأفعال والأقوال، مصدرها فُحْش . إذا كانت معرّفة (التعريف بأل) إما يكون للجنس أو للعهد لكن كثيراً ما استعملت في الزنا وقد تستعمل في غيره. في الزنا (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ (15) النساء) هذه في الزنى. وقد تستعمل في غيره كما في قوم لوط (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ (80) الأعراف) *أليست فعل اللواط وإتيان الذكران؟ طبعاً لكن هذا غير حكم، اختلفت الدلالة. إذن هي ما عظُم في الزنا وفي غيره. (وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا (28) الأعراف) يقال هذه عبادة الأصنام. (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا (19) النور) هو الافتراء والكلام، (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (30) الأحزاب) قالوا هذه معصية الرسول، العصيان للرسول هذا كبير. تأتي بمعنى القذف والفِرية وعبادة الأصنام وعموم ما عظم فعله من الأفعال والأقوال يسمى الفاحشة منها الزنا ومنها القذف ومنها الإفك ومنها عبادة الأصنام . *ما الدلالة بين التعريف والتنكير؟ |
|
|

|
|
|
#18 |
|
مشرفة قسم القرآن
       |
لمسات بيانية في سورة الليل للأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي استاذ الآدب في كلية اللغة العربية في جامعة الشارقة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ما الحكم البياني في استخدام بالفعل المضارع (يغشى) مع الليل والفعل الماضي (تجلى) مع النهار؟ سورة الليل تبدأ بقوله تعالى (والليل إذا يغشى) هو سبحانه أقسم بالليل وقت غشيانه ونلاحظ ان المفعول لفعل يغشى محذوف فلم يقل سبحانه ماذا يغشى الليل، هل يغشى النهار او الشمس لأنه سبحانه أراد ان يطلق المعنى ويجعله يحتوي كل المعاني المحتملة.(والنهار إذا تجلى) أي كشف وظهر. واستعمال صيغة المضارع مع فعل يغشى هو لأن الليل يغشى شيئاً فشيئاً بالتدريج وهو ليس كالنهار الذي يتجلى دفعة واحدة بمجرد طلوع الشمس. أي ان عملية الغشيان تمتد ولذا احتاج الفعل لصيغة المضارع، اما النهار فيتجلى دفعة واحدة لذا وجب استخدام صيغة الماضي مع الفعل تجلى. والآيات هنا مشابهة لآيات سورة الشمس في قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها) فصيغة الافعال متعلقة بالتجلي والغشيان. وما خلق الذكر والأنثى فا حكم (ما) في هذه الآية؟ هناك احتمالان لمعنى (ما): الاول أن (ما) اسم موصول بمعنى الذي. ويعتقد الكثيرون ان (ما) تستخدم لغير العاقل فيقولون (ما) لغير العاقل و(من) للعاقل ولكن الحقيقة أن ما تستعمل لذات غير العاقل كما في قوله: (يأكل مما تأكلون منه ويشر مما تشربون) ولصفات العقلاء كما في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (ونفس وما سواها) ويؤتى بها في التفخيم والتعظيم في صفات العقلاء، ولذلك قال تعالى (وما خلق الذكر والانثى) ويعني به ذاته العلية. ويحتمل ان تكون مصدرية بمعنى (وخلق الذكر والانثى)اي أنه سبحانه يقسم بخلق الذكر والانثى وليس بالخالق. وعليه فإن (ما) تحتمل أمرين إما ان الله عز وجل يقسم بذاته او أنه يقسم بفعله الذي هو خلق الذكر والانثى. فلو أراد تعالى أن ينص على أحد المعنيين لجاء بذلك ولقال سبحانه (والذي خلق الذكر والانثى) وتأتي ما بمعنى اسم موصول كما سبق أو قال سبحانه (وخلق الذكر والانثى) لتعطي معنى القسم بالفعل الذي هو خلق الذكر والانثى، ولكن الصورة التي جاءت عليها الآية تفيد التوسع في المعنى فهي تفيد المعنيين السابقين معاً وكلاهما صحيح. فيبقى مجال الترجيح في المجيء هنا بـ (ما) والاحتمال هو مقصود لإرادة ان يحتمل التعبير المعنيين الخلق والخالق، كلاهما مما يصح أن يقسم به خلقه والخالق وربنا سبحانه يقسم بخلقه ويقسم بذاته. و لو أردنا ان نرجح لقلنا أن القسم هنا القسم بالخالق والله أعلم . (وما خلق الذكر والانثى) لم يقسم بالمخلوق وإنما اقسم بالمصدر (أي خالق الذكر والانثى) أما الليل والنهار فهما مخلوقان فإذا اردنا المخلوق نؤل المصدر بالمفعول أحياناً فيصبح تأويل بعد تأويل أحياناً يطلق على المصدر ويطلق على الذات مثال: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) أحياناً يراد بالمصدر الذات. والخلق ليس مثل الليل والنهار. مثال: زرعت زرعاً في اللغة العربية زرعاً هي المصدر وأحياناً يضع العرب المصدر موضع الذات كقوله (نخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم) فالزرع هنا اصبح الذات واليس المصدر. سؤال: يقول السيد مصطفى ناصف في السياق اللغوي ان السياق هو الحقيقة الاولى والكلمة خارج السياق لا تفي بشيء وفائدة السياق اللغوي انه يحول معنى الكلمة من التعدد والاحتمال الى التحديد والتعيين. فلماذا لم يحدد ربنا في هذه الآية معنى (ما) ولم يترك المعنى هكذا بدون تحديد؟ جواب: هناك مبدأ عام في اللغة العربية: الجمل في اللغة على نوعين:
ومثال ذلك ايضاً لا النافية للجنس فهي قطعية كقولنا: لا رجل حاضر، فإذا قلنا: لا رجلاً حاضراً تحتمل الجملة إما نفي الجنس (الرجال) او نفي الوحدة (ولا حتى رجل واحد حاضر) وفي تحديدنا لهذه المعاني للجمل يجب مراعاة ما يريد المتكلم البليغ هل يريد الاحتمال او القطع.فالذي يريد الاحتمال له غرض من ارادة الاحتمال والذي يريد القطع له غرض من ارادة القطع وهنا تتفاوت البلاغة فالمتكلم البليغ يختار الجملة التي تؤدي المعنى الذي يريده. فالسياق لا يمكن ان يؤدي الى بيان المقصود لأن المقصود قد يكون هو الاحتمال بحد ذاته في القرآن يحذف حرف الجر وقد يكون هناك اربع احتمالات ومع هذا حذف الحرف لأن هذا ما أراده الله تعالى . وما خلق الذكر والأنثى ما المراد بالذكر والانثى هنا؟ قسم من المفسرين قالوا ان الذكر هنا هو الجنس البشري وقسم آخر قال انه كل ذكر او انثى من المخلوقات جميعاً بلا تحديد وهذا الذي يبدو على الارجح لأن سياق الآيات كلها في هذه السورة في العموم والله اعلم. إن سعيكم لشتى ما علاقة القسم (والليل اذا يغشى…) بهذا الجواب؟ منذ بداية السورة أقسم الله تعالى بأشياء متضادة: يغشى ، يتجلى، الذكر، الانثى، الليل، النهار فجواب القسم شتى يعني متباين لأن سعينا متباين ومتضاد فمنا من يعمل للجنة ومنا من يعمل للنار فكما ان الاشياء متضادة فان اعمالنا مختلفة ومتباينة ومن هذا نلاحظ أنه سبحانه أقسم بهذه الاشياء على اختلاف السعي (ان سعيكم لشتى) واختلاف الاوقات (الليل والنهار) واختلاف الساعين (الذكر والانثى) واختلاف الحالة (يغشى وتجلى) واختلاف مصير الساعين (فاما من أعطى … وإما من بخل واستغنى) والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى لماذا هذا الترتيب؟ نلاحظ ان الله تعالى بدأ بالليل قبل النهار لأن الليل هو اسبق من النهار وجوداً وخلقاً لأن النهار جاء بعد خلق الأجرام وقبلها كانت الدنيا ظلام دامس والليل والنهار معاً اسبق من خلق الذكر والانثى وخلق الذكر اسبق من خلق الانثى (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) فجاء ترتيب الآيات بنفس ترتيب الخلق: الليل اولاً ثم النهار ثم الذكر ثم الانثى وعلى نفس التسلسل. ما الحكم في عدم استخدام كلمة الزوجين في الآية ( وما خلق الزوجين الذكر والانثى)؟ كما يأتي في معظم الآيات التي فيها الذكر والانثى كقوله تعالى:( (فجعل منه الزوجين الذكر والانثى)(سورة القيامة) وقوله: (وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى)(سورة النجم) وانما قال: (وما خلق الذكر والانثى) بحذف الزوجين؟ إذا استعرضنا الآيات في سورة القيامة نرى ان الله سبحانه وتعالى فسر تطور الجنين من بداية (ألم يك نطفة الى قوله فجعل منه الزوجين الذكر والانثى) فالآيات جاءت اذن مفصلة وكذلك في سورة النجم (وأنه هو اضحك وأبكى الى قوله ,انه خلق الزوجين الذكر والانثى). لقد فصل سبحانه مراحل تطور الجنين في سورة القيامة وفصل القدرة الالهية في سورة النجم أما في سورة الليل فإن الله تعالى أقسم بلا تفصيل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قوله تعالى (إن سعيكم لشتى) يقتضي عدم التفصيل وعدم ذكر الزوجين. لماذا؟ لأن كلمة الزوج في القرآن تعني المثيل كقوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وكلمة شتى تعني مفترق لذا لا يتناسب التماثل مع الافتراق فالزوج هو المثيل والنظير وفي الآية (إن سعيكم لشتى) تفيد التباعد فلا يصح ذكر الزوجين معها. الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها (لتسكنوا اليها) وكلمة شتى في الآية هنا في سورة الليل تفيد الافتراق. فخلاصة القول اذن ان كلمة الزوجين لا تتناسب مع الآية (وما خلق الذكر والانثى)من الناحية اللغوية ومن ناحية الزوج والزوجة لذا كان من الانسب عدم ذكر كلمة الزوجين في الآية. هل يستوجب القسم في السورة هذا الجواب (إن سعيكم لشتى)؟ المقصود في السورة ليس القسم على أمر ظاهر او مشاهد مما يعلمه الناس ولكن القسم هو على أمر غير مشاهد ومتنازع فيه والله تعالى أوضح القسم (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) هذا الامر متنازع فيه واكثر الخلق ينكرونه (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) عموم الخلق لا يعلمون (فأما من أعطى…) ويتنازعزن فيه. والسعي هنا لا يدل على السعي في امور الدنيا من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها وانا السعي للآخرة. وكذلك قال تعالى (سعيكم) وكأنه يخاطب المكلفين فقط وليس عامة الناس ولذا أكد باللام أيضاً في (لشتى) ولم يقل إن السعي لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى لماذا لم يذكر المفعولين لفعل أعطى؟ اذا تدارسنا سورتي الليل والشمس لوجدنا ان القسم في سورة الليل وجواب القسم مطلق (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى) كلها مطلقة فلم يقل ماذا يغشى الليل ولم يحدد الذكر والانثى من البشر وكذلك جواب القسم في سورة الليل (ان سعيكم لشتى) مطلق ايضاً وكذلك (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) اطلق العطاء والاتقاء والحسنى. أما في سورة الشمس (والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناهاوالارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاهاوقد خاب من دساهاكذبت ثمود بطغواها..) في هذه الآيات تحديد واضح فقد قال تعالى يغشاها وجلاها وكذلك حدد في (ونفس وما سواها) خصص بنفوس المكلفين من بني البشر وكذلك في (كذبت ثمود بطغواها) محددة ومخصصة لقوم ثمود. فكأنما سورة الليل مبنية كلها على العموم والاطلاق في كل آياتها. وقد أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء (الليل والنهار وخلق الذكر والانثى) وذكر ثلاث صفات في المعطي (أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) وثلاث صفات فيمن بخل (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) في الآية (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) لم يذكر المفعولين المعطى والعطية والمراد بهذا اطلاق العطاء فلم يذكر المعطى او العطية لأنه أراد المعطي والمقصود اطلاق العطاء سواء يعطي العطاء من ماله او نفسه فقد يعطي الطاعة والمال ونفسه كما نقول يعطي ويمنع لا نخصصه بنوع من العطاء ولا بصنف من العطاء. وقد يرد في القرآن الكريم مواضع فيها ذكر مفعول واحد المراد تحديده وحذف مفعول يراد اطلاقه كقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) و (إنا اعطيناك الكوثر) أما في سورة الليل فحذف المفعولين دليل على العموم والاطلاق. فعل أعطى هو فعل متعدي ولازم فهل نقول على هذا الفعل أن السلوك الخاص به في الجملة سلوك لازم أي فعل متعدي أم حذف مفعول؟ قسم يقول أنه هذا حذف وقسم يقول عدم ذكر. حذف عندما يقتضي التعبير الذكر، مثل جملة الصفة لا بد ان يكون فيها ضمير يعود على الموصوف (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار) ويمكن أن نحذف كما في قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) هذا حذف. العائد للذكر فإذا حذف نقول محذوف كقوله: (ذرني ومن خلقت وحيدا) حذف الهاء في (خلقته). فيما عدى الذكر تنزيل المتعدي منزلة اللازم: لا يحتاج الى مفعول (ان في ذلك لآيات لقوم يعلمون) او لقوم يفقهون، يسمعون، لا يحتاج هنا الى مفعول ولا يريد ان يقيد العلم بشيء. وفي قوله: (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئاً) أراد أصل المسألة فلم يرد أن يقيد السمع أو البصر بشيء معين أما في (ولا يغني عنك من الله شيئاً) فيها ذكر واطلاق، وهل المعنى لا يغني عنك إغناءً او شيئاً من الأشياء؟ كل واحدة لها معنى وليست الاولى كالثانية. كذلك الفعل (اتقى). معنى اتقى هو احترز وحذر. والفعل اتقى هنا يراد به الاطلاق أيضاً ولم يقيده سبحانه بشيء فقد يقول (اتقوا النار او اتقوا يوماً) ولكن هنا جاء الفعل مطلقاً. فأما من أعطى واتقى تدل على أنه اتقى البخل. الحسنى: اسم تفضيل وهو بمعنى تأنيث الأحسن كما نقول (العليا – الاعلى، الدنيا – الادنى) والحسنى هو وصف مطلق لم يذكر له موصوف معين. وصدق بالحسنى معناها أنه صدق بكل ما ينبغي التصديق به قسم يقول انها الجنة وقسم يقول الحياة الحسنى وآخر الكلمة الحسنى (لا إله إلا الله) او العاقبة الحسنى في الآخرة وقسم يقول إنها العقيدة الحسنى ولكنها في الحقيقية تشمل كل هذه المعاني عامة، فكما حذف مفعولي أعطى واتقى للإطلاق أطلق الحسنى بكل معانيها بحذف المفعول وحذف الموصوف. ولو أراد سبحانه أن يعين الموصوف لذكره وحدد الفعل كما في قوله (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ولكنه أطلق لتتناسب مع باقي الآيات في السورة، فإذا اراد أن يطلق حذف. لماذا الترتيب على النحو التالي: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى)؟ هناك أكثر من سبب لذلك فقد قال قسم من المفسرين ان التقديم في سبب النزول لأن هذه الآيات نزلت في شخص فعل هذه الافعال بهذا التسلسل وقالت جماعة أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخرى قالت انها نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وترتيب العطاء ثم الاتقاء لأنه سبحانه بدأ بالأخص ثم ما هو أعم ثم ما هو أعم. كل معط في سبيل الله متقي ولكن ليس كل متق معطي فالمعطي إذن أخص من المتقي. وكل متق مصدق بالحسنى لكن ليس كل مصدق بالحسنى متق لذا فالمتقي أخص من المصدق بالحسنى وعلى هذا كان الترقي من الأخص إلى الأعم. إن سعيكم لشتى والسعي هو العمل وأقرب شيء للسعي هو العطاء. أما الإتقاء ففيه جانب سعي وجانب ترك كترك المحرمات وعلى هذا نلاحظ أن الآيات رتبت بحيث قربها من السعي أي بتسلسل العطاء ثم الاتقاء ثم التصديق وهو الاقل والابعد عن السعي. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى المجتمع يتكون من الذكر والانثى وأهم شيء يقدمه الانسان للمجتمع هو العطاء فهو اذن الدعامة الاولى لبناء المجتمع فعلى الانسان ان يكون معطياً لآ آخذاً وهذا يعني التآزر والتكافل ثم يلي ذلك الإتقاء وهو أن يحذر من الإساءة إلى الآخرين كما يحذر أن يضع نفسه في موضع الإساءة (أي يقي نفسه ويحفظ مجتمعه الذي هو فيه) لذا يأتي الإتقاء بعد العطاء. أما التصديق بالحسنى فهي من صفات المجتمع المؤمن وهي من الصفات الفردية فالمصدق بالحسنى لا يفرط في حقوق الآخرين . وعلى هذا الأساس قدم الله تعالى ما هو أنسب للمجتمع عامة: العطاء ثم الإتقاء ثم التصديق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ما معنى (فسنيسره لليسرى)؟ اليسرى في اللغة هي تأنيث الأيسر مضاد الأعسر او الأشق، يقال الامر اليسير والامر العسير، فاليسرى هو اسم تفضيل من الدرحة الثالثة أي اعلى درجات التفضيل. الحكم النحوي لليسرى: اذا كان اسم التفضيل مجرداً من (أل) او الإضافة او مضاف الى نكرة يصح التذكير (استخدام صيغة المذكر) فيقال أفضل رجل وافضل امرأة. أما اذا أضيف الاسم الى معرفة جاز فيه المطابقة وعدم المطابقة، فإذا عرف بـ(أل) وجبت المطابقة إلا إذا لم يسمع او لم يرد عند العرب. يقال: النار الكبرى. استخدام كلمة اليسرى جاء بالدرجة العليا من التفضيل من ناحية ونلاحظ انه ذكر الصفة ولم يذكر الموصوف ولو أراد أن يقيد او يحدد امراً محدداً لذكر وقال مثلاً الخلة اليسرى او العاقبة اليسرى او غيره تماما كما جاء في الاستخدام المطلق لكلمة الحسنى في الآية السابقة كما ورد ذكرها آنفاً. واليسرى يطلق على كل ما هو الايسر سواء من أعمال الدنيا او الآخرة، واليسرى تدور حول ثلاث محاور: الول: ان ييسر على غيره امورهم ويسعى في حاجتهم ويعينهم ويغيثهم ويعطيهم بمعنى يسر الله لخير غيره. والمحور الثاني أنه تتيسر اموره كلها ةتكون سهلة وميسرة عليه فيما يريد من أي ضيق وحالة تصيبه مداقاً لقوله تعالى: (يجعل له من أمره يسرا)، والمحور الثالث هو الآخرة بمعنى أن الله تعالى ييسره لدخول الجنة بيسر وسهولة وهذه عاقبة المحورين الاولين. إذن هي ثلاثة محاور تندرج تحت (فسنيسره لليسرى) وهذا مفهوم الآية. ورد في القرآن (ونيسرك لليسرى) وهنا جاءت الآية (فسنيسرك لليسرى) لماذا هذا الاختلاف؟ السين في اللغة تفتيد الاستقبال عند النحاة بالاجماع وكثير منهم يذهب الى ان السين تفيد التوكيد (يعني الاستقبال مع التوكيد) السين وسوف يفيدان التوكيد والاختلاف بينهما هو ايهما ابعد زمنا لكن الاثنين يفيدان الاستقبال مع التوكيد وقد بدأ بهذا الرأي الزمخشري، فالسين اذن هي للاستقبال المؤكد. في الآية الكريمة (ونيسرك لليسرى) هي خطاب للرسول الكريم r والرسول أموره كلها ميسرة دائماً في الحال وفي المستقبل لذا قال تعالى: ونيسرك لليسرى. أما في الآية (فسنيسرك لليسرى) فهي جاءت بعد الآية (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) بمعنى أن التيسير لليسرى في هذه الآية مرتبط بالعطاء والإتقاء والتصديق بالحسنى، فإذا أعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى عندها سييسرنا الله لليسرى. ما ارتباط (فسنيسرك لليسرى) بما قبلها؟ كما قلنا سابقاً التيسير لليسرى جاء على ثلاث محاور وقد قال تعالى: (فإما من أعطى) مرتبط بالمعنى الاول لأن الذي يعطي ييسر على الآخرين فأعانهم، الاعطاء هنا ينطبق على القسم المحور الاول من محاور التيسير. (واتقى) قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا) اتقى هنا تأتي مرتبطة بالمحور الثاني من محاور التيسير أي أن الله تعالى ييسر له اموره كلها. (وصدق بالحسنى) مرتبط بالمحور الثالث لليسرى لأن الله تعالى يجعل له العاقبة الحسنى ويدخله الدار الحسنى (للذين استجابوا لربهم الحسنى) فمن يصدق بالحسنى سيدخل الجنة بيسر وسهولة، فالآية مرتبطة بكل متعلقات (فسنيسره لليسرى). فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى تقابل هذه الصفات ما قبلها في الآية التي سبقت. وقد أورد الله تعالى امرين: الشيء ونقيضه فقال سبحانه: فأما من أعطى مقابلها فأما من بخل، واتقى مقابلها واستغنى، وكذب بالحسنى مقابل وصدق بالحسنى. والسورة كلها قائمة على التقابل: الليل والنهار، يغشى و تجلى، الذكر والانثى.. استغنى مقابل اتقى لأن المستغني لا يحذر شيئاً ولا يحترس والاستغناء مدعاة للطغيان كما في قةله تعالى: (إن الانسان ليطغى، أن رآه استغنى) والذي يطغى لا يحذر لأنه لو كان يحذر لما طغى أصلاً والمتقي يحذر ويحترس أما الطاغية فلا يحذر والطغيان مدعاة ااتعسير على الآخرين. كذب بالحسنى جاءت مقابل صدق بالحسنى، وكذلك جاءت (فسنيسره للعسرى) مقابل (فسنيسره لليسرى) ولم يقل نعسره للعسرى لأنها تفيد الثناء على عكس المقصود بالآية أنه يعسر الامور على غيره وعلى نفسه وفي الآخرة يعسر عليه دخول الجنة. وفي العسرى كما في اليسرى لم يذكر سبحانه وتعالى موصوفاً فتركها مطلقة وأعسر العسرى هي النار أعاذنا الله منها جميعا. والسورة بكاملها تفيد الاطلاق (يغشى ولم يحدد ماذا يغشى، تجلى ولم يحدد ماذا تجلى، الذكر والانثى ولم يحدد اهما للبشر فقط او لسائر المخلوقات، سعيكم لشتى ولم يحدد من عمل صالحاً مثلاً انما السعي على اطلاقه) فخط السورة اذن هو خط الاطلاق والعموم من أولها إلى آخرها. كما أنه لم يحدد الحسنى كذلك لم يحدد اليسرى ولم يحدد العسرى وحتى (من أعطى واتقى) لم يحدد العطاء والاتقاء. وما يغني عنه ماله إذا تردى لماذا جاءت هذه الآية عقب الآية السابقة: (فإما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) ولم تأت آية مثلها عقب الآية: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى)؟ في الآية ذكر الله تعالى أن الذي بخل، بخل بماله واستغنى من الغنى فلما بخل ذكر (ما يغني عنه ماله) و(ما يغني عنه ماله) وضع المفسرون لها احتمالين: الاول أن تكون نافية والثاني أن تكون استفهامية ومن باب التقريع والتوبيخ. ويسمى هذا في اللغة من باب الاتساع في المعنى، فلو أراد تعالى بالآية معنى الاستفهام لقال تعالى: (ماذا يغني عنه ماله) ولو أراد النفي لقال تعالى: (لم يغني عنه ماله) وانما جاء سبحانه وتعالى بلفظ يتسع للمعنيين وهو يريدهما معا فكأنما يريد القول ماذا يغني عنه ماله ولم يغني عنه ماله، اي يريد الاستفهام للتوبيخ والتقريع والنفي ايضاً ولهذا يضع سبحانه وتعالى جملة فيها اتساع في المعنى وهذا الاسلوب يتكرر في القرآن فقد يستعمل سبحانه وتعالى ألفاظاً تحتمل معاني عدة قد تصل إلى اربع او خمس معاني للفظ الواحد وهذا من البلاغة التامة حتى لا تتكرر الآية بمعنى مختلف في كل مرة وأنما يؤتى بها بلفظ معين يتسع لكل المعاني المقصودة. وهذا لا يعني تناقضاً او عدم تحديد في القرآن كما قد يتبادر الى اذهان المستشرقين لأن الله تعالى عندما يريد التقييد يأتي بحرف او كلمة محددة تفيد المعنى المراد كما في قوله سبحانه: (اذكروا الله ذكراً كثيرا) فقد حدد هنا الذكر الكثير وفي موضع آخر (واذكروا الله كثيراً) لم يرد التقييد ولم يحدد انما اطلق المعنى. فالقاعدة أن ننظر ماذا يريد المتكلم البليغ، هل يريد التحديد فهو يحدد. في الآية الكريمة: (ولا تشركوا به شيئا) سورة النساء، آية 36، فيها اطلاق والآية: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فيها تخصيص. في الآية الاولى لا ندري ما المقصود بـ (شيئا) هل شيئا من الاشياء التي يشرك بها كالأصنام او الاشخاص او غيره او المقصود شيئا من الشرك (شرك أعلى او شرك أصغر) ولو أراد أن يخصص لقال كما في الآية (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) سورة الكهف، آية 110، أحدا هنا لا تحتمل غير معناها لأنها محددة. لذا فإن الآية (ولا تشركوا به شيئا) تحتمل المعنيين والمراد منها أن لا نشرك بالله شيئا من الشرك او شيئا من الاشياء كالأصنام والبشر وهذا يسمى اتساع في المعنى. مثال آخر في الآية: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) سورة النساء، آية 160، هل المعنى خلقا كثيرا او صدا كثيرا او زمنا كثيرا؟ انها كل هذه المعاني الصد الكثير والخلق الكثير والوقت الكثير ولو أراد سبحانه أحد هذه المعاني فقط لجاء بلفظ يدل على المعنى المطلوب ولحدد وخصص. ما الحكم البياني في استخدام (إذا) بدلا عن (إن): (وما يغني عنه ماله إن تردى) بدل (وما يغني عنه ماله إذا تردى)؟ إذا في كلام العرب تستعمل: · للمقطوع بحصوله كما في الآية: (إذا حضر أحدكم الموت) ولا بد ان يحضر الموت، (فإذا انسلخ الاشهر الحرم) ولا بد للأشهر الحرم من أن تنسلخ، وقوله تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت) ولا بد للشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا قضيت الصلاة) ولا بد للصلاة أن تنقضي. · وللكثير الحصول كما في قوله تعالى: (إذا قمتم الى الصلاة..) و (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها) تفيد الحدوث الكثير. واذا جاءت (إذا) و(إن) في نفس الآية تدل (إذا) على الكثير و(إن) على الاقل كما في قوله تعالى: (وإن تعجب فعجب قولهم ءإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ) سورة الرعد، آية 5، والآية: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا) سورة المائدة، آية 6، فإقامة الصلاة أكثر حدوثا من الجنابة لذا استعملت (إذا) مع اقامة الصلاة و(إن) مع الجنب. والآية:( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب) سورة النساء، آية 25. فالمحصنات أكثر من اللواتي يأتين بفاحشة مبينة. (إذا) وردت في القرآن الكريم في 362 موقعاً ولم تأت في موقع غير محتمل البتة فإما أن تأتي بأمر مجزوم بوقوعه كما في الآيات التي تصف الآخرة كقوله: (إذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت…) وقوله: (إذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت..) لأن كل آيات الآخرة مقطوع بحصولها، او كثير الحصول كما ورد سابقاً. (إن) تستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل او مشكوك فيه او نادر او مستحيل كما في قوله: (أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) الموقف هنا افتراضي، وقوله: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا..) لم يقع ولكنه احتمال. وقوله تعالى: (انظر الى الجبل فإن استقر مكانه..) افتراضي واحتمال وقوعه. والتردي حاصل والتردي اما أن يكون من الموت او الهلاك، او تردى في قبره، او في نار جهنم فماذا يغني عنه ماله عندها؟وهذه ليست افتراضاً وانما حصولها مؤكد وهي امر حاصل في كل لحظة ولهذا السبب جاء بلفظ (إذا) بدل (إن) لأن (إذا) مؤكد حصولها) و(إن) مشكوك فيها او محتمل حدوثها. وهذه إهابة بالشخص أن لا يبخل او يطغى او يكذب بالحسنى،إذن لا مفر منه فلماذا يبخل ويعسر على الآخرين ويطغى ويكذب بالحسنى؟ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى ما هو المعنى العام للآيات وارتباطها بما سبقها وما تلاها من الآيات؟ إن علينا للهدى هذا التعبير (إن علينا للهدى) يحتمل معنيين: الاول علينا أن نبين طريق الهدى بمعنى أن الله تعالى يتكفل ببيان طريق الهدى، والثاني أن الهدى يوصل صاحبه الى الله. طريق الهدى في النتيجة يوصل الى الله عز وجل (إن ربي على صراط مستقيم) (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) من أراد أن يبتغي مرضاة ربه يسلك هذا الطريق ومثلها قوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل) والقصد هو استقامة الطريق. فمعنى الآية علينا ان نبين الطريق المستقيم والطريق المستقيم يوصل الى الله تعالى. ما الحكم البياني في التقديم والتأخير في الآية (إن علينا للهدى) بدل القول إن الهدى علينا؟ التقديم في هذه الآية يفيد القصر. إن معرفة وتقديم الخبر يفيد القصر. طريق الهدى يبينه الله تعالى فقط وليس هناك معه جهة أخرى، أي ان الهدى يعود الينا (أي الله تعالى) حصراً وأي هدى من غير طريق الله فهو غير مقبول ومرفوض ولا يوصل الى الله عز وجل. فالجهة التي تبين طريق الهدى هو الله تعالى حصراً. وقول: إن الهدى علينا يتضمن المعنى السابق لكنه لا ينفي كون جهة اخرى توصل الى الهدى ولكن الله تعالى حصر الهدى به جل وعلا. ما الحكم البياني في استخدام التوكيد بـ(إن) وبـ(اللام)؟ التوكيد يكون بحسب الحاجة وبحسب إنكار المخاطب للأمر. إذا كان المخاطب يقبل الامر لا يوجد داعي للتوكيد لكن أكثر الناس يرفضون هذا الأمر لقوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وهذا الشيء ينازع فيه كثير من الناس في زمن الرسول او الآن ويرفضون الفكرة وينسبون الهدى لأنفسهم وأنهم هم الذين يبينونه وينازعون فيه لذا وجب التوكيد، لذا المسألة تحتاج الى توكيد بالمعنيين: الهدى علينا حصراً والمعنى الآخر: طريق الهدى هو الطريق الذي يوصل الى الله. ولو جاءت الآية (إن الهدى لعلينا) هذا يؤكد المعنى الثاني ويؤدي الى فوات معنى الحصر الأول. في عموم القرآن هناك ارتباط بين الآيات وما يسبقها او يليها، (إن علينا للهدى)مرتبطة بما قبلها (إن سعيكم لشتى) لأنه لو ابتغى الناس الهدى عند الله لما تشتت سعيهم ومرتبطة بالآية (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) لأنها من الهدى الذي ييسره الله تعالى. وإن لنا للآخرة والأولى وهذه الآية مرتبطة ايضاً بما قبلها (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) لأن الذي يعطي ويتقي يريد الآخرة فقال الله تعالى (إن لنا للآخرة) والذي يبخل يريد الدنيا فقال تعالى (والاولى) فالآخرة والاولى لله وحده فيجب ان نتبع هدى الله تعالى في الاولى والآخرة. ومرتبطة كذلك بالآية (فسنيسره لليسرى) (فسنيسره للعسرى) لأن التيسير والتعسير إما أن يكونا في الدنيا او في الآخرة ولله الآخرة والأولى. إذن علينا ان نتبع ما أراد الله منا. ما الحكم البياني في تقديم الآخرة على الأولى؟ التقديم والتأخير في القرآن عموماً مرتبط بسياق الآيات فأحياناً يقدم المفضول على الأفضل وقد يقدم المتأخر على المتقدم. ولو نظرنا في سياق الأيات في هذه السورة لوجدنا أن الله تعالى قدم الآخرة لتقدم طالبها (فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى) وأخّر الاولى لتأخر طالبها (فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى). في سورة القصص وردت الآية: ( فله الحمد في الأولى والآخرة) أي تقدم ذكر الاولى على الآخرة وفي سورة الليل تقدم ذكر الآخرة على الأولى فما الفرق بين الآيتين؟ في سورة القصص سياق الآيات (70 – 73) هو في نعم الدنيا من الآية: (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيع ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فالسياق كله في الدنيا وما أودع الله تعالى من النعم في الأولى. فلذا ناسب تقديم الاولى على الآخرة في سورة القصص. وقال تعالى: (وله الحمد) ايضاً الذي يدل على أن النعم يجب أن تقابل بالحمد والشكر والاختيار ناسب السياق للآيات وهو تذكير للإنسان بنعم الله تعالى في الدنيا. اما في سورة الليل فقال تعالى (إن لنا للآخرة والأولى) لم يذكر الحمد وقدم الآخرة كما سبق وفصلنا. والتوكيد بـ(اللام) في كلمة (للآخرة) فيه اختلاف مع آية سورة النجم (فلله الآخرة والأولى) فما الحكم البياني في هذا التوكيد في سورة الليل؟ التوكيد في سورة الليل جاء مناسباً لسياق الآيات، فسياق الآيات في ورة الليل جاء كله في الاموال وامتلاكها والتصرف فيها (فأما من أعطى) والمعطي لا بد ان يكون مالكاً لما يعطيه، (وأما من بخل واستغنى) والبخيل هو أيضاً مالك للمال لأنه لو لن يكن يملكه فبم يبخل؟ وكذلك الذي استغنى وهو من الغنى ثم ذكر المال (وما يغني عنه ماله إذا تردى) و (الذي يؤتي ماله يتزكى) فالسورة كلها في ذكر الاموال وتملكها والتصرف فيها فلذا ناسب التوكيد باللام هنا لأن الآخرة والاولى من الملك لله حصراً. أما في سورة النجم فسياق الآيات ليس في المال ولا في التملك اصلاً فلم يؤكد باللام. في الآية جاءت كلمة (الأولى) مقابل (الآخرة) ولم ترد مثلاً كلمة (الدنيا) مقابل (الآخرة) ما الحكم في اسخدام الأولى بدل الدنيا؟ الحقيقة أولاً وللعلم لم يرد في القرآن الكريم كله ولا مرة واحدة لفظ الدنيا مع الآخرة إنما ورد دائماً كلمتي الأولى والآخرة. ولهذا اسبابه البيانية:
فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى هذه الآيات مرتبطة بقوله تعالى (إن علينا للهدى* وإن لنا للآخرة والأولى) لأن هذا من الهدى. أنذرنا هو من الهدى الذي ينبه الله تعالى منه (إن علينا للهدى) وهذا في الآخرة فهي مرتبطة بـ (وإنا لنا للآخرة). وفي سورة الليل ذكر الله تعالى الإنذار ولم يذكر التبشير ولذلك اقتصر على ذكر النار ولم يذكر الجنة لأن ذكرها تبشير وليس هنا مقام التبشير. كما ذكر للأشقى صفتين: التكذيب والتولي، (الذي كذب وتولى) كذب: بمعنى كذب بكل مفردات الإيمان، وتولى بمعنى أدبر عن الطاعات واشتغل بالمعاصي. فجاءت كذب مقابل (وصدق بالحسنى) وتولى وقابل (أعطى واتقى) لأن عدم العطاء من التولي. وهذه الآية (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) توكيج للآية السابقة (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) وهي أعم منها ايضاً لأن التولي أعم من البخل والاستغناء فالتولي لا يقتصر على البخل والاستغناء انما هو تولي عن كل الطاعات وادبار عنها عموماً. وكذّب أعم من (كذّب بالحسنى) لأنه كذّب بالحسنى وبغير الحسنى. إذن لما عمّ السوء وانتشر أصبحت العاقبة أشد من الأولى و لما كان هذا أعم كانت العاقبة أسوأ لأن الأول بخل واستغنى وكذب بالحسنى وهذا كذب عموما وتولي عام لذا كان يجب أن تكون العقوبة أسوأ، أولاً وصفه بالأشقى وذكر أن له ناراً تلظى أما في الآيات السابقة اكتفى بـ (فسنيسره للعسرى) وهذه العاقبة أخف. ما الحكمة في الإتيان بفعل (فأنذرتكم) بصيغة الماضي وقد ورد هذا الفعل بصيغة المضارع في آيات أخرى في القرآن؟: جاء الفعل بصيغة المضارع لأن الله تعالى أنذرهم هنا بشيء واحد ألا وهو ناراً تلظى بمعنى شيء واحد وانتهى، كما في قوله أيضاً (فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) و(إنا أنذرناكم عذاباً قريبا). أما في قوله تعالى (إنما أنذركم بالوحي) فالإنذار هنا مستمر طالما الوحي مستمر بالنزول ولا ينتهي لذا جاءت صيغة الفعل المضارع. ما الحكم البلاغي في مجيء الآية (فأنذرتكم ناراً تلظى) بدون توكيد على خلاف ما جاء في سورة النبأ (إنا أنذرناكم عذاباً قريبا). سورة النبأ فيها توكيد لأن الإنذار في سورة النبأ متسع ومتكرر من أول السورة الى أوسطها ألى آخرها (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) (إن جهنم كانت مرصادأ للطاغين مآبا،…جزاء وفاقا..فذوقوا ..) (إنا أنذرناكم عذاباً قريبا) فهو إنذار متسع طويل وفيه بسط ومتصل ومكرر فهو أدعى للتوكيد من سورة الليل. أما في سورة الليل فلم يرد الإنذار إلا في آية واحدة لذا لا تحتاج إلى توكيد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى لماذا لم ترد الآية على نفس سياق ما قبلها (ولا يجنبها إلا الأتقى) لا تصح لأن في هذا جلالة على أنه لن يجنبها إلا الأتقى بمعنى أن المتقون لن يحنبوها وفي هذا ظلم للمتقين وحاشا لله أن يكون هذا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده لأن معنى الآية أن الله تعالى يجنب الأتقى وغير الأتقى أيضاً فرحمته سبقت غضبه. في العذاب حصر (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) وفي الرحمة أطلق سبحانه هو الرحيم. إجمالاً في هذه الآية والتي قبلها ذكر مقابل الأشقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فالصفة العليا (الأتقى) الذي يؤتي ماله (الوصف الأعلى للإنفاق ولم يقل من ماله إنما قال ماله ولم يقل المال) والتزكي (أعلى درجات التصديق). في السيئة بدأ من الخاوص إلى العموم (أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) وفي الحسنة ترقى من الأفضل إلى الأفضل (الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) أعطى مقابل يؤتي ماله، وواتقى مقابل الأتقى وصدق بالحسنى مقابل يتزكى لأن صدق بالحسنى هي أعلى التدرجات لأن فيها الإخلاص. سيجنبها: استخدم الفعل بصيغة المبني للمجهول فلماذا لم يستخدم الفعل (سيتجنبها)؟ الآية فيه تحذير وإنذار عظيم إلى الناس لأن الأتقى لا يتجنبها بنفسه وإنما الأمر يعود إلى خالق الخلق وخالق النار ، فالله تعالى هو الذي يجنب عباده النار ولا أحد يستطيع أن يتجنبها بنفسه ابدا. ونظير هذه الآية ما جاء في قوله تعالى (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) سورة مريم. لا يستطيع الناس أن ينجوا بأنفسهم من النار ولو كان أحدهم الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إنما ألمر يعود لخالق الناس وخالق النار سبحانه. جاء في كثير من الآيات في القرآن الكريم قوله تعالى (ينجي الله) (ننجي الذين اتقوا) فما الحكمة في الآية هنا (سيجنبها الأتقى)؟ هناك فرق بين التجنيب والتنجية. التنجية قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته كما في قوله (وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب) يمعنى أنهم ذاقوا العذاب ثم نجاهم الله تعالى فكانت النجاة بعد الوقوع في المكروه. وكذلك قوله تعالى (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) بعدما وقعوا في النار يبنجي الله تعالى الذين اتقوا. وكذلك في قصة سيدنا يونس u (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) سورة الأنبياء، آية 88، كان قد وقع في الكرب ثم نجاه الله تعالى منه . إذن النجاة تقع بعد الوقوع (ننجي الذين اتقوا). أما التجنيب فهي التنحية بمعنى أنه لا يقع في المكروه أصلاً (سيجنبها الأتقى) والأتقى في المرتبة الأعلى فهو لا يقع في التجربة أصلاً. ذن مع اتقوا يستعمل القرآن لفظ (التنجية) ومع الأتقى يستعمل (التجنيب). وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلاّ ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عندما يؤتي ماله ليس لأحد فضل عليه يؤديه له وإنما يفعله لوجه الله تعالى وعمله غير مشوب بشائبة فهو لا يرد معروفاً لأحد وإنما ابتغاء وجه الله من غير توقع رد جميل وإنما هو خالص لوحه الله وهذا هو منتهى الإخلاص. ليس لأحد فضل فيجازيه عليه وإنما يفعله خالصاً لوجه الله تعالى. ولسوف يرضى: فيها احتمالين أن تكون للشخص الذي يرضى بثوابه في الآخرة (الأتقى الذي أعطى ماله) أو هو الذي يبتغي وجه ربه الأعلى إذن سيرضى الله عنه، وهي الحالتين معاً سيرضى بثوابه فيما أعج الله تعالى له من كرامة ورضوان الله أعلى شيء ( ورضوان من الله أكبر) أكبر من الجنات. وقالوا في الأثر: تحتاجون لعلمائكم في الجنة كما كنتم تحتاجون إليهم في الدنيا قالوا كيف يا رسول الله قال يطلع الله على أهل الجنة فيقول سلوني سلوني ولا يعرفون ما يسألونه فيذهبون إلى علمائهم فيقولون ماذا نسأل ربنا فقالوا اسألوه رضوانه وهو أعلى شيء. الخطوط التعبيرية في السورة: خط العموم، خط المقابلة، خط التفضيل. خط العموم: السورة كلها في العموم من قوله تعالى (والليل إذا يغشى) لم يذكر تعالى ناذا يغشى و(النهار إذا تجلى) (وما خلق الذكر والأنثى)، (إن سعيكم لشتى) (فأما من أعطى ) أطلق العطاء وأطلق جهة العطاء وأطلق اتقى ماذا اتقى. النار، غير النار، (صدق بالحسنى) ما هي الحسنى؟ (فسنيسره لليسرى) ما هي اليسرى؟ اسلاميات |
|
|

|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| لمسات بيانية الجديد 13 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 04-17-2024 04:59 AM |
| لمسات بيانية الجديد 12 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 04-16-2024 08:00 PM |
| لمسات بيانية الجديد 11 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 04-16-2024 07:57 PM |
| لمسات بيانية الجديد لسور القرآن الكريم 4 | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 11-03-2023 09:58 PM |
| لمسات بيانية الجديد لسور القرآن الكريم 3 كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 07-11-2023 08:57 PM |
|
|